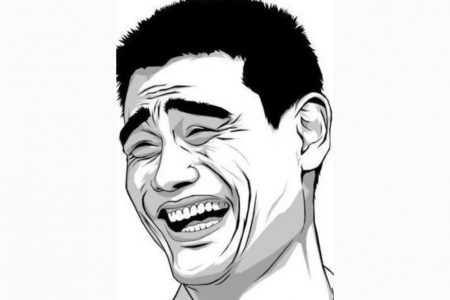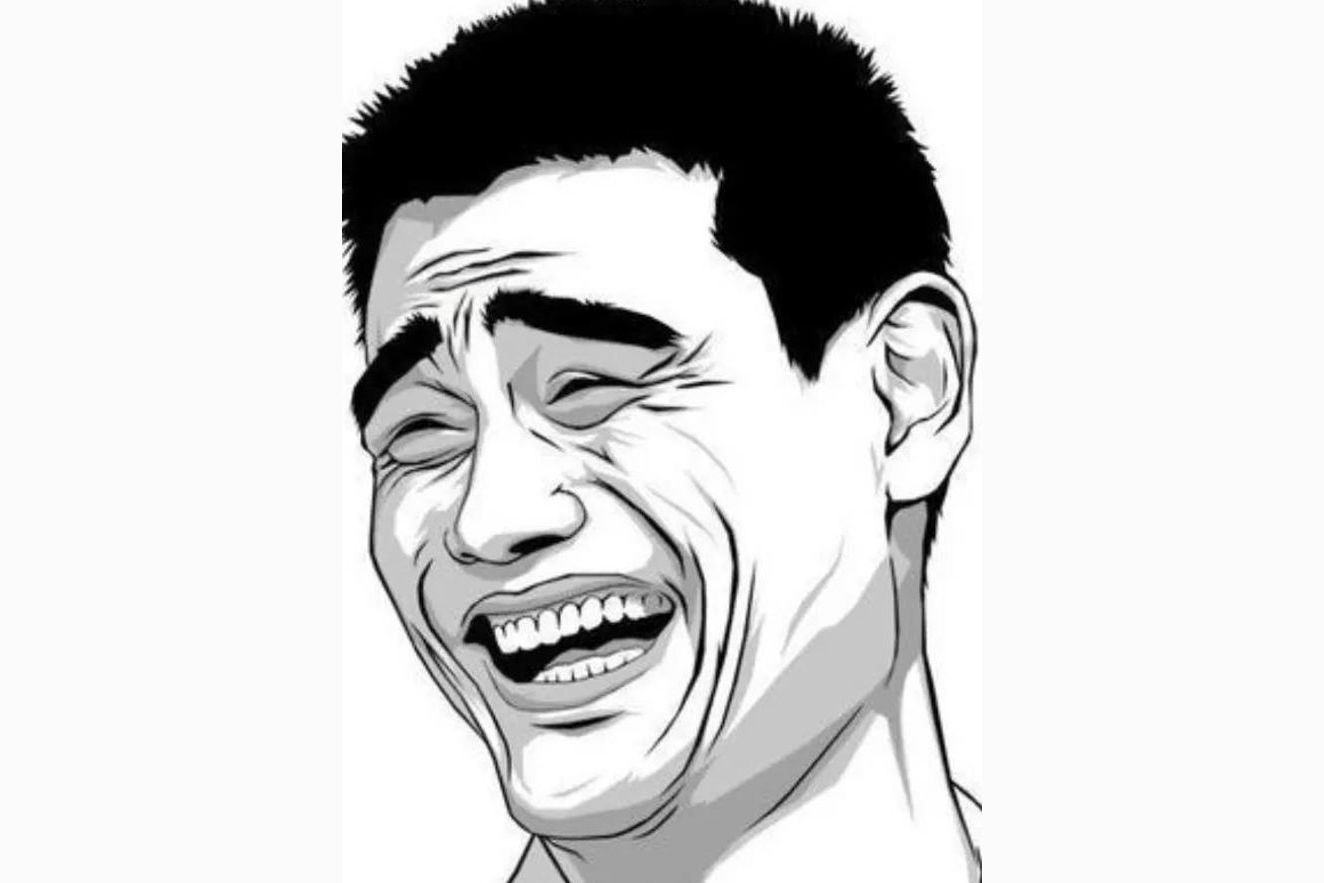
يظهر موقف ما لشخصية عامّة على فيسبوك فيشبعها المتابعون شتمًا وتخوينًا، والأسوأ من ذلك كلّه ابتداع النكات الكثيرة وربط المواقف بطرق كوميدية مختلفة، وترك ذلك المستنقع من النكات منطقة موبوءة دون تجفيف أو معالجة حقيقية.
باتت تلك المستنقعات من النكات غير المجدية كثيرة جدًا، أصبحت الفكاهة أشبه بمخدّر اعتدنا عليه دون فائدة سوى إدمان الضحك على خيباتنا.
وأتساءل حقًا: هل علينا الضحك على خيباتنا؟
هل هناك شابّ يضحك بسبب بطالته؟ أو أنثى تضحك بسبب تعنيفها؟ أو طفل يضحك بسبب رحيل عائلته؟
في الحالة المنطقية لا يمكن ذلك، لكن في حالة من الهذيان يمكنه أن يضحك ألمًا، حين يصل المرء إلى حالة من التعب النفسي ولا يمكنه أن يقوم بأي حلًّ منطقيّ آخر،
فهل وصلنا إلى تلك المرحلة؟!
يقول سيغموند فرويد في كتابة (النكات وعلاقتها بالوعي): “إن النكات تبعث على المتعة؛ لأنها تمثل مقاومة داخلية تم التغلب عليها.” ويضيف: “سر متعة النكتة يكمن في ضغط وتركيز اللغة لإيصال أهدافٍ مكبوتة في التعبير عن العداوة.”
وتقول الكاتبة (ليزا وادين) في كتابها (السيطرة الغامضة): “الباحثون الذين يستندون إلى تعريف فرويد ذاك يركزون على (العداوة المكبوتة أو الرغبة العدوانية) التي تمكّن قائلها من التغلب عليها من خلال النكتة.”
يعود بنا هذا السياق إلى الكوميديا السوداء التي استخدمها نظام الأسد لترسيخ حكمه، من خلال عدم مواجهة المشكلات بشكل حقيقيّ في عمليّة معقدّة من “المطاوعة” تزيد من ثبات حكمه وتؤكد عدم القدرة على المواجهة وبقاء الشعب في حالة استسلام دائم.
قد يفوق عدد النكات التي تم ابتداعها من بداية الثورة إلى اليوم عدد الاجتماعات التي تم عقدها والبيانات التي تم إعلانها، كما يفوق عددها عدد الشخصيات العامة التي تم تخوينها وإسقاطها خلالها، ولا يستثنى منهم إلّا الذين ماتوا ونجَوا من تلك النكات، من الجيد أن يبقى الموت صك غفران فعّال إلى يومنا هذا.
فإن كانت جميع الشخصيات العامة التي تسلّمت موقع اتخاذ القرار ضد مصلحة الشعب، فما تركيبة ذاك المجتمع الذي لم يصدر إلى واجهته إلّا الخونة وأصحاب المصالح الشخصية؟
تتكون البرلمانات في جميع الدول من مجموعة أحزاب تتقبل وجود بعضها البعض دون أن تتفق على التفاصيل، وقد يكون الاختلاف بين أعضاء الحزب الواحد أيضًا، وقد يحتوي ضمن صفوفه يمينًا ويسارًا معًا.
في خمسينيات القرن الماضي تقارب حزب الشعب مع حزب الأخوان المسلمين، فنتج عن ذلك دستور 1950 الذي تغنينا به في بداية الثورة طويلاً، قد لا يتوافق ذاك الدستور مع واقعنا الحالي، لكنّه كان نتيجة الفكر السائد آنذاك، ورغم اختلاف واقعنا مع نتائجه إلاً أن طريقة إنتاجه ما زالت مطلوبة، أن تكون القوانين متناسبة مع الجميع ولا تناسب مقاسًا واحدًا فقط بل تناسب جميع المقاسات.
يغيب هذا المشهد عن أبسط التجمّعات لدينا فيكون الجميع بطابع واحد وبمجرد أن يختلف أحدهم بتفصيلٍ ما يُقصى عن المجموع الباقي، فالاختلاف لدينا يفسد كل القضايا وليس الود فقط، ففي صفوف المعارضة أسقط اليمين واليسار والإسلامي والعلماني والليبرالي والعربي والكردي، وبدل أن يُخرج الموكل بالمهمّة أفضل ما لديه خلال فترة تسلّمه، يخرج أكثر المبررات إقناعًا للجمهور متنحيًا في النّهاية عن المشهد برمّته، بعضهم وضع خلاصة تجربته في كتاب ما لعلّ هنالك جيلاً ما يأخذ تجربته على محمل حسن.
ونتساءل اليوم: هل جيلنا لا يقوى على صناعة الحلول وليس بإمكانه سوى صناعة النّكات السخيفة؟!
إسقاط الأشخاص شعبيًا طريقة اتبعت مع أكثر الشخصيات إجرامًا دون أن تجدي نفعًا، وما زلنا نتبعها اليوم مع شخصيّات أخرى دون فعل حقيقي، خلال ١٠ سنين كانت تتحوّل جميع المشكلات الخلافية إلى مجموعة نكات دون فعل حقيقي.
ففي كلّ مرة تمرّر نكتة جديدة لأصدقائك تذكر أنّك ترسخ مطاوعة جديدة لمستبدٍّ ما، والأجدى بك أن تبحث عن حلول مناسبة، وبدل إسقاط شخصيّة أو التبرير لها اِبحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تلك المواقف.
تغيير منظورنا للمشكلات من ترسيخ المطاوعة بصناعة النكات إلى إيجاد الحلول هي الطريقة التي يمكن بها أن نخرج من مباركة الثورة في عامها العشرين 2031 إلى احتفالنا بإيجاد طريقة للخروج من تلك المأساة.